
منذ بداية السبعينيات، وقبل أن تبدأ حرب إعادة التوحيد الوطني، كانت أجهزة استخباراتنا تشير من حين لآخر إلى أخبار عن رجل الشارع مفادها أن بعض الضباط ينوون القيام بانقلاب. ومعلوم أن تلك الأجهزة آنذاك ما تزال في طور النشأة، ممثلة في مكتب الدراسات والتوثيق التابع لرئاسة الجمهورية وإدارة الأمن التابعة لوزارة الداخلية. غير أن تلك الأخبار، التي أصبحت أكثر اطراداً بعد انطلاقة الحرب، لم تقدم شيئاً محدداً، ومع ذلك عززتها معلومات وردت من الخارج. فقد أطلعني الملك الحسن الثاني أثناء لقائي به في مراكش خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 1977، على معلومات وردت إليه تفيد بأن انقلاباً يتم الإعداد له بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقد ذكر مضيفي أن مصدر تلك المعلومات هو شاب موريتاني يدعى ولد الوافي الذي قدَّم في البداية أخباراً سرية إلى الأستاذ بوعبيد مفادها أن الجيش الموريتاني يعد انقلاباً للإطاحة بي. ثم أدلى ولد الوافي نفسه بمعلومات مماثلة إلى أحد أعضاء الديوان الملكي قام بتسجيلها. وقد اقترح الملك أن يمدني بنسخة من التسجيل الصوتي. ولكنى رغبت بلباقة عن هذا العرض نظراً إلى أنني لا أودّ أن يتدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية ولو كان صديقاً وحليفاً مرموقا. فهل كنت على حق؟ الله أعلم.
وقد أبلغني الرئيس موبوتو في شهر فبراير 1978، وأنا في ابروكسل، أن «... المعلومات الملتقطة من أوساط المعارضة الزائيرية في بلجيكا، تفيد بأن الجيش الموريتاني يعد انقلاباً للإطاحة بك. وقد ورد اسم أخٍ لسفيرك هنا ضمن المتآمرين...». ويتعلق الأمر بالرائد أحمدو ولد عبد الله قائد المنطقة العسكرية السادسة المكلفة أساساً بالعاصمة، وهو ابن عم السفير المعني وسميه.
وخلال اجتماع المكتب السياسي الوطني المنعقد يوم السبت 8 من يوليو 1978 أطلعنى أحمد ولد الزين، عضو تلك الهيئة، على فحوى حديث دار بينه وبين سيدي أحمد ولد ابنيجاره عشية اليوم السابق مؤداه أن انقلاباً وشيكاً قد تم الإعداد له بتمالؤ من كافة مسؤولى الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك قائد الأركان الوطنية وقواد المناطق العسكرية وقائدا الدرك والحرس الوطني. وقد أحلت أحمد ولد الزين على وزير الدفاع الوطني محمذن ولد باباه الحاضر بدوره اجتماع المكتب السياسي الوطني بحكم عضويته فيه. ولم أشعر أي أحد سواه بالخبر بما في ذلك وزير الداخلية ممادو ساغو.
لكن لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ لأنني فكرت في أمرين:
- أحدهما أن يكون الأمر مجرد إنذار كاذب، وفي تلك الحالة فإن الوقت غير ملائم لتثبيط عزائم قواتنا المقاتلة بإظهار أي نوع من الريبة نحوها في وقت تحتاج فيه إلى أقصى ما يمكن من التشجيع لتمكينها من القيام بمهمتها المقدسة المتمثلة في الدفاع عن حوزة الوطن المهددة.
- أما الأمر الثاني فهو أن تكون المعلومات دقيقة، ويلزمني بالتالي أن أفكر مليا في أنجع السبل لمواجهة الوضع الجديد. وبما أن المعلومات شبه مؤكدة، فقد كان علي أن آخذها بالحسبان وأن أفكر في فرضيات شتى للتصدي للموقف. وكانت أول فكرة خطرت ببالي هي، بطبيعة الحال، البحث عن طريقة لإفشال خطة الانقلابيين. فكيف ذلك؟ يتطلب الأمر اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء في اليوم نفسه لعزل المسؤولين العسكريين الضالعين في العملية وتعيين من يخلفهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. وهكذا يتكفل وزير الدفاع الوطني بمن يدخلون ضمن دائرة اختصاصه. وتصبح إذاعة قائمة بأسماء الضباط المعزولين ومن حل محلهم كافية لمباغتة الانقلابيين وإفشال خطتهم. وقد راودني هذا الحل للوهلة الأولى، لكنني عدلت عنه في النهاية لعدم التأكد من نتائجه. وعليه، فإن عدم الجزم - أو نقص الحزم كما يحلو للبعض أن يقول - جعلني أتخلى عن ذلك الخيار لسببين لا يختلفان كثيراًً:
- أولهما خطر المواجهة بين الأوفياء من جيشنا وقوات أمننا وبين الانقلابيين، وما ينجر عنها من سفك الدماء في صفوف هؤلاء وأولئك.
- أما السبب الثاني فمرتبط بالانعكاسات السلبية الكبيرة لمثل هذا الوضع على مقاتلينا في خطوط الجبهة. وبالفعل، فإن حرمان قواتنا - ولو لوقت قصير - من قياداتها المحلية ومسؤوليها على مستوى الأركان في نواكشوط، سيعرضها للتشوش والهلع بل وللفوضى. وفي سياق مشابه تصبح أكثر هشاشة وضعفا في مواجهة العدو. ولتفادي هذا الاحتمال، وبعد تفكير ملي، قررت بكامل الوعي وإملاء الضمير أن «أتركهم يفعلون ما يريدون».
فقد فضلت التضحية بنفسى وتحمل النتائج المترتبة عن فقد السلطة عوضا عن إثارة صدامات دامية وشقاقات لا تجبر بين صفوف مواطنينا وإضعاف مقاتلينا الذين يجابهون العدو في ظروف صعبة آنذاك. فهل كان هذا هو القرار الأمثل؟ إن الحكم على ذلك متروك للتاريخ، وأرجو أن يكون حكما موضوعياً. ولكن ما يهمني قبل كل شيء هو حكم الله، ذلك الحكم الذي أرجو به النجاة في الدار الآخرة.
وفى الوقت الذي أنهى فيه تحرير هذه المذكرات، فإن رأيي لم يتغير وما زلت أفكر بالطريقة نفسها.
وبوسعي أن أتفهم أنني قد أصبحت عقبة في نظر البعض، بمن فيهم العسكريين. وقد كان بوسعي أن أتنحى طواعية شريطة استمرار نضالنا من أجل إعادة توحيد الوطن بشكل قد يكون أفضل. وبالمقابل لا يمكنني أن أتصور أن وطنيين وضباطا موريتانيين سيتركون مكاسب عشرين سنة من جهودنا تنهار خلال بضعة أيام وأسابيع أو أشهر. كما لا أستطيع أن أتصور تراجعهم واستسلامهم. لذا ألتمس الصفح من مواطنينا عن النقص في تصور ما آلت إليه الأمور.
وقبل الحديث عن الانقلاب، تجدر الإشارة إلى أنني ترأست مؤتمرا يوم 3 من يوليو 1978 ضم جميع المسؤولين العسكريين على المستوى الوطني والجهوي، واستمر ذلك اللقاء ثلاثة أيام. وخلال جلسة الافتتاح، بادرت إلى التنبيه إلى أن نقاشاتنا يجب أن تسودها الحرية المطلقة وأن يعرب كل واحد عن ما يدور بخلده دون أدنى تحفظ.
وقد استعرضنا الأوضاع العسكرية بكافة جوانبها في جلسات مغلقة، وأعرب الجميع عن الصعوبات التي تعترضهم في مجال الوسائل البشرية واللوجستية. ولم ألاحظ أي موقف «جبان» ولم أسمع أي كلام انهزامي. ومع أن المشاركين لا يبدو عليهم التحمس، فإن الجو العام يطبعه الارتياح. وعليه، يمكن القول إنهم استطاعوا إخفاء نواياهم الانقلابية بمهارة ونفاق.
ولدى اختتام المؤتمر، ركزت بإلحاح على قضيتين هما متابعة حرب التوحيد الوطني وإدانة الرشوة. فقد أكدت في القضية الأولى على أن بلدنا المعتدى عليه سيستمر في الدفاع حتى النهاية ولن يستسلم. أما في القضية الثانية، فقد أنذرت من أخاطبهم عواقب اختلاس الأموال الموضوعة تحت تصرفهم وسوء تسييرها الذين أصبحا حديث الناس. وقد أعلنت لهم «أنني لن أقبل تصرفات سيئة كهذه. ففي الوقت الذي يكافح فيه البلد من أجل البقاء، تزدهر الأعمال وتسود اللامبالاة واستغلال النفوذ. لقد آن الأوان لتملك النفس ومحاربة الرشوة والسباق نحو الامتيازات والثراء الفاحش لدى العسكريين والمدنيين على حد السواء».
إن هذه الأقوال لم ترق كثيراًً لمستمعي على ما يبدو، فهل كان لها أي دور في المسار الذي آل إلى الانقلاب؟ لا أعلم. وعلى أية حال، فقد رأى البعض - بمن فيهم بعض معاوني - أن ما قلته في الاجتماع العام لكافة كبار المسؤولين العسكريين كان بالإمكان التعبير عنه بطريقة أقل صراحة (مراعاة لحساسيات المخاطبين وكبريائهم). ولم أكن بطبيعة الحال أتبنى هذا الرأي. ولذلك أبلغت في مراسلاتي التي وجهتها في تلك الفترة إلى وزير الدفاع الوطني وبقية الوزراء، عن الضباط السامين الذين لا يوفون بالالتزامات المستحقة عليهم. وقد نُص عليهم بالاسم وحددت مبالغ المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.
(7).jpeg)
* *
وسأتطرق بإيجاز في الصفحات التالية إلى الفترة التي كنت فيها رهن الاعتقال منذ فجر العاشر من يوليو 1978، مروراً بفترة الإقامة بالهندسة العسكرية، وسفري من نواكشوط إلى ولاته عبر العيون والنعمة في الخامس عشر من يوليو 1978، وإقامتي بولاته منذ ذلك اليوم وحتى الثاني من أكتوبر 1979 وما تخللها من ظروف صحية استدعت رحلتين قصيرتين إلى كيفة. ثم سفري من ولاته إلى نواكشوط مروراً بالنعمة والعيون. ويتعلق الأمر باختصار بفترة اعتقالي وما تخللها من أحداث تاريخية أود أن أسلط عليها ما أمكن من أضواء كاشفة حتى يدركها من لم يعشها من مواطنينا.
ففي ليلة الاثنين العاشر من يوليو، كنت نائماً بمفردي في غرفة النوم الموجودة بالطابق العلوي من القصر الرئاسي، في حين كانت مريم في سفر إلى دكار على رأس وفد من النساء الموريتانيات للمشاركة في مؤتمر للحقوقيات. وكانت نفيسة ترعى أطفالنا الثلاثة وهم نيام في غرفتيهم الكائنتين في نفس الطابق العلوي الوحيد بالقصر. وفي حدود الساعة الرابعة صباحاً، استيقظت على أصوات عدد من محركات السيارات تتوقف أمام المنزل قرب سارية العلم. وقد استنتجت من هذا الحضور الغريب أن الأمر يتعلق بغاصبين. وعندها نهضت وارتديت الملابس الوطنية التقليدية. وما هي إلا لحظات حتى دق باب غرفتي، ففتحت فإذا أمامي مرافقي العسكري الملازم الأول مولاي هاشم ومعه شاب آخر في نفس الرتبة لا أعرفه. وقد علمت فيما بعد أنه الملازم الأول المختار ولد السالك أخو الرائد جدو ولد السالك. ويرافق هذين الضابطين ثلاثة جنود مسلحين. وقد خاطبني الملازم الأول مولاي مؤديا تحية عسكرية خاطفة، ولا إرادية فيما يبدو، قائلاً بتلعثم وعصبية شابها أدب: «السيد الرئيس، لقد سحب منكم الجيش ثقته فلتتفضلوا بمرافقتنا». وفي هذه اللحظة انتابتني رغبة عابرة للشروع في نقاشات قانونية لتوضيح أن الجيش لا يستطيع انتزاع ما لا يملك، وأن عليه أن يلتزم حدود الشرعية القانونية. ولكنني عدلت تلقائياً عن الفكرة التي خطرت بي ولم أنبس ببنت شفة. وتابعت خطا زواري حتى هبطنا إلى الطابق الأرضي حيث كانت سيارة لاندروفير في انتظارنا ملاصقة لباب الصحن. وأثناء صعودي إلى السيارة، طلبت من مرافقي أن يذهبوا بأطفالي، بعد استيقاظهم إلى منزل أختي أمامه وابن خالي أحمدو ولد محمود لابراهيم.
ثم ركبت إلى جانب السائق الذي ارتعش بقوة لدرجة أنه لم يتمكن من تشغيل المحرك رغم ما أحدثته رزمة مفاتيحه من ضوضاء، ولذا طلبت منه أن يهدأ. واستطاع في النهاية أن يشغل المحرك وينطلق. وكان الملازم الأول المختار يجلس خلفى ومعه جنديان. أما الملازم الأول مولاي فكان أمامنا في سيارة لاندروفير تتقدم الركب. وتبعتنا مجموعة من سيارات لاندروفير. وقد سارت القافلة عدة كيلومترات على طريق الأمل قبل أن تحول اتجاهها إلى مقر الهندسة العسكرية المعروف اختصاراً بـ«جيني». وفي الطريق انحنى الملازم الأول المختار نحوي قائلاًً في أدب وتأثر باد من الصوت: «السيد الرئيس اطمئنوا فلن يصيبكم أي مكروه».
فأجبت قائلاًً: «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».
ولاحظت فور وصولنا «جيني»، الواقعة وقتها على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرقي نواكشوط، وجود كثير من الجنود في حالة تأهب عند بوابة المعسكر وحول كتلة البيوت حيث يوجد المكتب الذي آواني قرابة ساعتين، وهو على ما يبدو مكتب قائد المعسكر. وقد بقيت في هذا المكتب وحيدا جالسا على كرسي أشعر براحة بال تامة منذ البداية.
ويحرس المكتب جنديان ملثمان يقفان طورا ويمشيان طوراً آخر أمام الباب. وعند بزوغ الفجر طلبت وَضوء، فأحضره أحد الجنود في إناء ومعه حوض بلاستيكي ومنشفة. ثم قدم لى غطاء نظيفا يحل محل سجادة للصلاة. وبعد أن أديت الصلاة، اقترح علي بالإيماء أن أستريح على سرير من أسرة المعسكر وضع في زاوية من المكتب. والغريب أن هذا الجندي المهذب في سلوكه لم يسألنى ولم يجبنى إلا بالإشارة، فلماذا؟ لا أدرى. وعلى كل فقد أجبته نطقا أنى لا أرغب في الاضجاع، ولا أشعر بالنصب. ولذا أفضل البقاء جالسا في الكرسي أفكر في هشاشة كل ما هو بشري وضعفه…
وفى حدود الساعة الثامنة وقفت أمام المكتب شاحنة صغيرة مغطاة من طراز 404 أو405 وطلب منى أحد حارسي المكتب في أدب، وبأسلوب الإشارة دائما، أن أخرج من المكتب واستقل السيارة. وهكذا جلست بجنب السائق الذي كان ملثما هو الآخر.
وفي الخلف ملازم أول شاب وعدد من الجنود المسلحين. وقد لاحظت أثناء عبورنا لجزء من المعسكر أن وضعية الجنود لم تعد على ما كانت عليه إبان وصولنا. وتوقفت السيارة أمام فيلا زينت بعض أجزائها أزهار نبات الجهنمية. وكان ينتشر من حولها العديد من الجنود المسلحين.
وأمام هذه الفيلا، استقبلني قائد المعسكر النقيب آتيى بأدب وأدى لي خلسة تحية عسكرية لا إرادية، فيما يبدو، على غرار ما وقع للملازم الأول مولاي.
أما ما يتعلق بسلوك العسكريين تجاهى خلال فترة اعتقالي (من 10 يوليو 1978 إلى 2 أكتوبر 1979)، فالحق أقول إننى لم أتعرض في أي لحظة لأدنى تصرف غير لائق من حراسى في السجن. فلم يخطئ في حقى أي عسكري، ضابطا كان أو ضابط صف أو جنديا، بل إنهم على العكس من ذلك عاملوني بإجلال. فقد ظل كل واحد منهم يبرهن حسب أسلوبه ودرجة تحضره على ما يكنه لى من احترام.
وقد رافقنى النقيب آتيى وأحد ضباط الصف إلى الغرفة الرئيسة في الفيلا، وهي غرفة متسعة غطيت أرضيتها بالزرابي، تحتوي سريراً كبيراًً ودولاباً به مرآة. وفي الغرفة المجاورة توجد مرافق للنظافة والاستحمام ودورة مياه مزودة بالماء البارد والساخن بفضل مسخنة تعمل بالغاز. ويفصل الغرفة عن بقية الفيلا صحن صغير. ثم سألنى النقيب آتيى عن الوجبة المفضلة لدي في الإفطار والغداء والعشاء، مبيناً أن كل ما أرغب فيه متوفر بما في ذلك القهوة والشاي الموريتاني والإنجليزي والحليب والخبز والأرز والمعاجين والكسكس واللحم. وقد تعجبت من تلك الوفرة واخترت وجباتى اليومية، تلك الوجبات التي ظلت تقدم بانتظام طيلة مقامى في «جيني» وولاته وكيفه. ففي الصباح أتناول الحليب الساخن أو الطازج إن توفر. وفي الزوال والمساءً يكون التناوب بين وجبة من الأرز باللحم أو الكسكس واللحم. وكانت الوجبات المذكورة تشفع بوجبتين إضافيتين إحداهما ضحى والأخرى بالآصال. وتعرف هاتان الوجبتان ببنافه والعقبية حسب اصطلاح أهل أطار. وتتكون كل منهما من شواء متنوع تتلوه دورة شاي أخضر. والمحصلة النهائية هي خمس وجبات في اليوم!!
ولتفادى البدانة، كان علي أن أحد من الأكل، فكنت أكتفى من بعض الوجبات باللقمة أو المضغة. أما بالنسبة للشاي الموريتاني، فأتناول منه يومياًً 15 كأسا صغيرة، بمعدل ثلاثة كؤوس بعد كل وجبة!
ولا يعنى استعراض هذه الحصيلة أنني كنت نهماً، ولكن تلك الوجبات اليومية الخمس تركت إيقاعها في استخدام جدول زمني الاجتماعي على مدى خمسة عشر شهرُا، حيث كانت فرصة للتحدث مع المرافق الذي يعد الشاي، والطباخ، وأحياناًً أخرى مع المساعد أو الملازم رئيس المركز. ومهما يكن، فإن «من استضافوني» لم يبخلوا علي بالطعام.
وسأعود إلى الوراء قليلاً لأصف أول وجبة إفطار تناولتها في «جيني». فقد كانت حسب طلبي مؤلفة من كأس كبير من الحليب الساخن والشاي الموريتاني. وقد أعد ذلك الشاي على طريقة أعوان الحرس أي أنه كان عاليَّ التركيز! وعلى الفور طلبت أن يكون أقل تركيزا وأكثر خفة، وكان لي ما طلبت. وكان هذا الشاي يعد في صحن الفيلا الصغير، ويتولى أحد الجنود مناولتي الكأس مترعة ويعود بها فارغة، ثم يقوم بإغلاق الباب بالمفتاح. وبعد نهاية الشاي بقيت في الغرفة خلف أبواب موصدة. وعندها تمددت استعدادا للنوم. وما هي إلا هنيهة حتى دُق الباب وفُتح ودخل جنديان يحملان طبق شواء به أجزاء طرية من لحم خروف (أَفَشَايْ) ذبح للتو وفق تقاليد ضيافتنا الأصيلة. وتولى أحد الجنديين تقطيع أجزاء اللحم التي يقع اختيارى عليها، في حين استأنف الثاني مهمة تقديم الشاي.
وكان «زواري» في البداية كلما فتحوا الباب الخشبي أغلقوه خلفهم بالمفتاح مما يجعل الغرفة مظلمة عند إطفاء الضوء، مع أن لها بابا مزدوجا من الزجاج. ولذا طلبت منهم أن يستخدموا ذلك الباب وامتثلوا الطلب. وبحلول الساعة الحادية عشرة لم أعد حبيس الباب المغلق.
وبعيد الظهيرة، حمل إلي النقيب آتيي من المنزل «كرتونا» يحتوى على أدوات نظافتي الشخصية وبعض الملابس الموريتانية. ثم عاد من جديد ليقول «... اطمئنوا فكل شيء على ما يرام». فسألته عن زوجي وأطفالى، فأجاب أن الكل بخير. فمريم تقيم بقصر الرئيس سينغور بدكار، أما الأطفال فمع أختي أمامة كما أمرت. كما طلبت منه مصحفا وجهازا إذاعيا يعمل بالبطاريات، فلبى الطلب دون تأخير. وعلى الفور، أكدت إذاعة فرنسا الدولية الأنباء المتعلقة بوجود مريم في دكار. أما إذاعة نواكشوط فمكنتني من التعرف على قائمة اللجنة التي شكلها الإنقلابيون وعلى رئيسها المصطفى ولد السالك. وكنت أعرف العديد من هؤلاء إما بوصفهم معاونين مباشرين سابقين مثل المرافق العسكري ورئيس ديواني العسكري، أو بوصفهم ضباطا سابقين أعيروا للعمل بالإدارة الإقليمية.
لقد بدأت إذاعة نواكشوط «تغتاب» النظام المخلوع وتتهمه «بكل خطايا إسرائيل». وبكل بساطة، تحولت تلك الإذاعة إلى بوق دعاية يمجد الانقلابيين ويخيل إلى السامع أن البلاد ستعيش في ظلهم عهدا فردوسيا.
وعند سماعي قائمة من ساندوا الانقلابيين، حقاً كانت أم باطلة، لم أتمالك عن الضحك، لأن هؤلاء كانوا بالأمس القريب يتبارون بحماس نضالي داخل حزب الشعب الموريتاني. وقد قادني هذا إلى التفكير مليا في هشاشة العواطف والسلوك البشري ومزاجها المتقلب. إنها قاسم مشترك كما يقال... ولم يكن الأمر مفاجئاً لي على الإطلاق. فقد كنت أكرر على الدوام أنني أتوقع كل شيء ومن أي كان ما دمت رجلاًً سياسياًً. ومع أنني لم أكن نزاعا إلى الريبة، بل كنت أمنح الشخص كامل الثقة، فقد كان الشك يخامرنى باستمرار في صدق نوايا أولئك الذين يعلنون على رؤوس الأشهاد مدى تعلقهم بالسلطة القائمة وإخلاصهم لها... ولذا وجدت أن علاقاتي الشخصية السابقة لسنة 1957 كانت أكثر صدقاً وتجردا، إذ نسجت تلك العلاقات بين فلان والمختار وليس بين فلان والرئيس المختار. وكانت هناك لحسن الحظ بعض الاستثناءات، لكنه الشذوذ الذي يثبت صحة القاعدة.
إن انتهازية أصحاب رسائل المساندة التي بثتها الإذاعة تذكرنى بنموذج مشابه لأحد الانتهازيين تضمنه بيت من الشعر الشعبي (كَاف) يقول صاحبه:
سِيدِ ذَاكْ اَلْجَاكُمْ فَاتْ أكَبَلْكُمْ جَانَ............. وَاسْوَ عَادْ اَمْعَاكُمْ وَاسْوَ عَادْ اَمْعَانَ
ومؤدى هذا الكَاف: أن سيدي الذي أصبح الآن في صفكم كان فيما مضى في صفنا، ولا نبالى إذا كان معكم أو كان معنا.
وفى صبيحة الحادي عشر طلبت بعض الجرائد، فاستجيب لطلبى بسرعة، حيث حصلت على جريدة الشعب الموريتانية بالعربية والفرنسية، وجريدتي لصولي Le Soleil السينغالية، ولموند Le Monde الفرنسية.
وفي يوم 12 طلبت من النقيب آتيى، الذي تبين أنه عضو في اللجنة العسكرية، أن يحضر لى بعض الكتب التي أتذكر مواقعها بالضبط في مكتبتى. ومن بينها كتب بالعربية تشمل كتاباً في السنة وأغلب أعمال طه حسين وثلاثة كتب أهداها إليَّ أمير سوكوتو أثناء زيارتى الرسمية الأولى لنيجيريا بدعوة من الجنرال يعقوب كَاون. وكان أحد الكتب الثلاثة مخطوطا نادرا للشيخ عثمان دان فوديو. أما الكتب الفرنسية التي طلبت فهي مجموعة «الأفارقة Les Africains» المنشورة من قبل جان آفريك Jeune Afrique. وفي المساءً نفسه أحضرت تلك الكتب.
وفي 13 أعلنت للنقيب آتيى رغبتي في إيصال رسالة إلى ابن خالي أحمدو ولد محمود لإبراهيم، وكان رده مشروطاً بالتعليمات التي سيتلقاها من قادته بهذا الشأن. وقد أعطانى الموافقة في اليوم نفسه، وسلمته الرسالة الموجهة إلى أحمدو. وفي الغد (14 يوليو) جاءني بالرد من عنده. وقد حملت تلك الرسالة أخباراً سارة عن كافة أفراد الأسرة، ذكر فيها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مريم، وأن الأطفال يقيمون معه، والوالدة بخير وكذلك سائر أسرتى من الطرف الأمي والأبوي.
وقد أعلمنى النقيب عشية ذلك اليوم قائلاًً: «إن عليكم سفرا قصيرا في الصباح الباكر ويفضل أن تكونوا جاهزين عند الساعة الرابعة والنصف...
يتبع ان شاء الله

.gif)
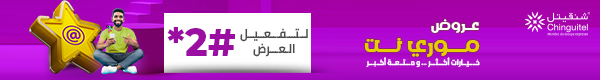
.jpg)





