
سنتناول اليوم إحدى أهم القصص المحلية التي كتبتها الظاهرة الادبية والمبدعة المتميزة المعروفة في الاوساط الثقافية باسم : "الدهماء ريم" والتي تلألأ نجمها وسطعت شمسها في السنوات الاخيرة كإحدى أهم الكتاب الموريتانيين وأرسخهم قدما ,وأبرعهم قلما.
نعم ..حين تقرأ لها أي نص ,سواء كان مقالا أو قصة ,أو خاطرة ,ستدرك أنك أمام شلال متدفق ينساب كما تنساب مياه نهر جار في رحلة سرمدية تجعلك فاغرا فاك لا تدري هل البداية أجمل أم النهاية ,المنبع أمتع أم المصب أروع..
وحين تطوف بك "الدهماء ريم" بين سطور وصفحات قصة جنوح الفرقاطة "لا مديز" على السَّواحل الموريتانية، تجعلك تغرق في تفاصيل غاية في الدقة والاتقان ,وستحس بلذة لا عهد لك بها ,وتود لو تلتهم الزمن وتختصر المسافات لتشارك أبطال القصة في تلك الأحداث "التراجيدية" التي رسمتها "الدهماء" بحِرفية ومهارة حتى بدت كأنها لوحة فنية تتداخل فيها الالوان فتحولها من حالة محسوسة إلى حالة مرئية.
مقدمة بقلم / محمد محمود محمد الامين
قصة جنوح الفرقاطة "لا مديز" على السَّواحل الموريتانية (المنشور الخامس والأخير)
أنا وابنتي.. واللوحة الخالدة.
....ا
في سنة 1818م، ألْهَمَت قصَّة "لا مديز" الرَّسام الجمهوري Théodore Géricault (الصورة 8)، وقرَّر تثبيت اللحظة في عمل فنيٍّ مُلفتٍ، جمع وثائق كثيرة، ومن أهمّها كتاب "كوريار آلگزاندر" والجرَّاج "هانري سافيني"، قابَلَ الضَّحايا، وعاشَرَ مِشرحة الموتى للتَّعود على لون الجُثث وتقاسيمها، فأعادَ بجَمالٍ مُرعبٍ تشكيل لحظة ما قبل الانقاذ مُباشرةً على طوَّافة الموت، في لوحة زيتية بالحجم العملاق، أخذتْ منه سنة كاملة من الجدِّ، وهي لحظة ظهور السفينة L’Argus ، في الأفق قادمة اتّجاه الطوافة لإنقاذ من تبقى عليها، وكان الرَّسام وقتها في عمر السَّابعة والعشرين، وأطلق بذلك حركة الرّومانسية في فرنسا، كثَورَة ضد الأرستقراطية والمعايير الاجتماعية والسّياسية في عصر التَّنوير، وقد أثارت اللوحة امتعاض الملك لويس الثامن عشر، وقال بالحرف:«إنَّ فرنسا ليست بحاجة لمثل هذه اللَّوحة»، لكن اللَّوحة أجبرت مع ذلك الملك على التَّعامل بجدِّية مع فضيحة "لا مديز"، تمامًا كما كان التّقرير البحريّ للجرَّاح "سافيني" مُؤثِّرا على الرأي العام، بعد أن سرَّبه إلى الصحافة وزير الدّاخلية الشاب، المكلف بالشّرطة.
في سنة 1817م استقال وزير البحرية، ووجَّه مجلس الحَربِ البحري إلى القبطان Chaumareys تُهَمَ: إغراق السفينة بالجهل، ومغادرتها في تخلٍّ عن المسؤولية، وقطع حبال القوارب عن الطوافة، وهو القرار الذي تدافع مسؤولية اصداره مع الحاكم العسكري للسنغال.. حُكم عليه بثلاثِ سنوات من السِّجن، وشُطِب اسمه من قائمة ضبَّاط البحرية، ومُنع من الخدمة بتاتًا، كما جُرِّد من أوسمته في ذاتِ الجلسة، وعاش مُنعزلًا بقية حياته في قلعة صغيرة يملكها تدعى Le Château de Lachenaud في قرية "بوفي" ، بمدينة "ليموج" الفرنسية، يرجمه الأطفال بالحجارة كلُّما تجاسر وخرج للشَّارع، انتحر ابنه فرارًا من العار.. عاش 25 سنة بعد ذلك، وتُوفيَّ في سن الثامنة والسبعين سنة 1841م ، وإمعانا في إهانته دُفن في المقابر العامَّة... بينما حصل الحاكم على وسام تقدير!.
مات الملك الويس الثامن عشر حاملاً استياءه من الدَّلالات التي كشفت عنها لوحة Le Radeau de la Méduse ، ومنها تَعبيرها المجازي عن عَدَم كفاءته، كان الملك وسيمًا، ودُوداً، كسولاً، بطيئاً، سميناً، مُصاباً بداء المفاصل، ولم يكن في كُلِّ حالاته مَلكاً، أمَّا اللَّوحة العِملاقة فمعروضة اليوم بأناقة الجَمال الفرنسيِّ، في قاعة "مُولْيانْ" ذات السِّحر الارجواني، المُحتضنة لأعمال القرن التاسع عشر بمتحف اللوفر(الصورة 9)، هذه اللَّوحة من أبْدَعِ وأبْلغ الأعمال الفنية، وكانت الكِتَاب الأسمَى الذي تجاوز الذَّاكرة البشرية المحكية نحو التوثيق للحادثة.
عُثر على حطام الفرقاطة "لا مديز" سنة 1980م قبالة شواطئنا، بفضل المسح المغناطيسي، ألِّفَت حولها العديد من الرِّوايات والأفلام......... (انتهت القصة).
....ا
ابنتي!،
قرأنا المراجع معاً، فما كنتُ لأدلِّلها بالقراءة عنها بالوكالة، فما دامت مهتمَّة عليها أن تَبذُلَ جُهدا ذاتيًّا لتكتشف، قَرَأَت لي مقاطعَ كثيرة، كانت تقرأ، وكنت أترجم مُسايرة، تلوَّنَت تقاسيمها مع الأحداث، تعكَّرت تفاعُلاً، تعجُّبًا، رفضًا، ألماً.
ذهن ابنتي مشحون بمثاليَّاتٍ ما تزال بكرًا، مُحلِّقة، لم تُعكِّرها بعدُ شوائب التَّجربة، أو خبرة الحياة،.. تساءلتْ في حسرة: لِمَ لَمْ يُعدَم القبطان الذي لطَّخ شرفه المهني كما ينُصُّ القانون، ولعلَّه بذلك يتخلَّص من عار الأبد بالموت على الأقل؟،.. أجَبتُها: ابنتي، لأنه نبيلٌ ملكيٌّ، نُبْل تَمْييزٍ موروث،.. لقد تفرَّق دم جريمته في المنظومة المُذنبة التي صَنَعَته بالمُحاباة، وبإعدامه سيعدمون أنفسهم،.. كذلك لأنَّ القانون طبقيّ ومُجامل للمحظيِّين، وأصحاب النَّبالة العُليا، ولأنَّ من وضعوا القانون من المخمليِّين كانوا في صَفِّه،.. إعدامه لن يُعَلِّي موته لأرفع من موتِ حَقارَةٍ، موتٌ لن يُطهِّره من الذَّنب التَّاريخي،.. فلو كان ماتَ فوق حُطام الفرقاطة "لا مديز" لمُنح موت عَظَمَة، لكن مَوت العَظمة يحتاج منه نُبلاً عسكريًّا مُكتَسَبًا بخشونة الجندية، وهو ما لم يكن في حالته، ولذلك حَكم عليه التَّاريخ بموتٍ باردٍ في قبوِ قلعته الفارغة.
تساءلتْ كذلك في ألمٍ مُقرفٍ، كيف يَكْفُر الانسان بآدميَّته بهذه البساطة، ويُسقط القيَّم الانسانية دفعة، كيف أعدَمَ رُكَّاب الطَّوافة صُحبتهم في الرِّحلة، زملاء العمل، رفاق السلاح والحياة، كيف مزَّقوا جثثهم، وأكلوا لحمهم، كيف -بربِّ السَّماء-دفعوا بهم أحياء للحيتان، وكلّ ذلك في سبيل بقاءٍ بشعٍ ذميمٍ، لم يَحمِلهم لأبْعد من الانتحار والجنون، وغَصَّة بعقدة الإثم؟،..
أجبتها: هو استسلام لرغبة أكثر إلحاحًا من صوت الإنسانية، ومن وخز الضَّمير وممَّا سبق ورَاكَم العُمر من طبقات الأخلاق، ففي المواقف المُسجَّلة على شفير الحياة، على شفا الوجود من عَدَمِهِ، تكون هذه المعاني رفاهية مَنطقٍ بلا معنى وبلا منطق، فعلى تلك الحافَّة الحادَّة يُعاد تأسيس العلاقة بين البشر على أساس الغريزة فقط وصراع البقاء، ينفكُّ الارتباط بالفطرة السَّليمة وتطفو البدائيَّة.. وغير ذلك ابنتي ترفٌ عبثيٌّ..
"طوَّافة لا مديز"، ملحمة مأساوية، حكاية انسلاخ من القيم البشرية في لحظة عَجْزٍ عن اطعامٍ من جُوع، وعن أمنٍ من خوف، هكذا تنشط غرائز الانسان حين ينتقل فجأة من النظام إلى اللاَّنظام، هكذا كان،.. ولم يزل كذلك فالغريزة أزليَّة.. نحن نعيش اليوم على طوافة كبير تُدعى مجازًا الأرض،.. ويأكل بعضنا البعض في وحشيَّة.
.....ا
بعثُ أحداث التاريخ من مرقدها إحساس لطيف، كُلَّما لاحَ بجانبي أعاكِسه، وخصوصًا إن التزم لي الأسمراني "خليو" بطرب المواكبة .
....ا
أغلب المعلومات الواردة ترجمة عن أرشيف فرنسي (الصورة 10)، ولترطيب الذاكرة استعنتُ بالمكتبة الإلكترونية لأخي العزيز وصديق عمري محمدن احمد سالم، وليست المَّرة الأولى، له منِّي ألف شكر من القلب.
تحياتي
لمتابعة كل الحلقات... يرجى الضغط هنــــــا



.gif)
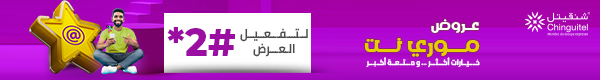
.jpg)





