
كانت أول مرة أسمع فيها اسمه أو أرى سحنته في أروقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية صيف 1997.
رأيت شابا يافعا يخطب أمام مئات الطلاب المعتصمين المطالبين ببعض الحقوق البسيطة التي تواجهها إدارة الجامعة بالتعنت والمماطلة. كان واضحا من خلال نبرة الصوت، وطريقة الحديث أن خطاب ذلك الفتى يتسم بالوضوح والبلاغة الصلبة. تلك البلاغة الخادمة للحق، لا "البلاغة الركيكة" (على حد تعبير نيتشه) الخاضعة للظلم والقبح.
انطلق وديعة من الجامعة مناضلا، مناصرا للقضايا العادلة. والعدل مبدأ يبصره مطاردُه في كل مسارح الحياة؛ في غبن الطلاب، أو تهميش شريحة من المواطنين، أو ممارسة المذابح ضد مكون اجتماعي وطني، أو ضد الفلسطينيين. انطلق وديعة في رحلته المقدسة ضد الظلم، ومنذ انطلق ما فتر. فلم تفتنه المنعرجات الحادة المبررة بإكراهات الواقع، ولا ملّ طول الطريق الموحشةِ التي يصطف على جانبيها من يحاول مساعدتهم وهم يرمونه بالحجارة، بينما ينخرط هو –غير آبهٍ- في معمعة الكفاح ليحررهم...وهم لا يعلمون.
مرت سنون، سافر خلالها صاحبكم ثم عاد إلى البلاد السائبة عام 2002. فوجدت الوديعة كما تركته، صامدا متقدما الصفوف صلبا بليغا. ألفيته هذه المرة رئيسا لتحرير إحدى أهم الصحف في البلاد. وصلت ضحى إلى مكتب الجريدة التي يديرها. كان لا يعرفني، ولم يسمع اسمي قط.
طلبت لقاءه، فخرج ماشيا بتؤدة تعلو محياه ابتسامة واثقة.
اسمي فلان بن فلان... عندي هذا المقال أود التكرم بنشره.
ثم ناولته ورقة واحدة مملوءة بخطي العادي.. جدا.
جلس أمامي وبدأ يقرأ النص حالا. كان أول رئيس تحرير أو ناشر يقرأ لي نصا. رفع رأسه وقال:
يا سلام! أبشر.
وانتظرت بحرقة ليخرج مقالي في الجريدة. وهذا شعور يفهمه من جربه من أصحاب "صناعة الكلام"، على لغة أبي عثمان. خرج المقال بعد أيام. سعدت يومَها جدا بذلك، وأنا اليوم أسعد وأفخر بأن أول قارئ لي كان ذلك الفتى... أحمد الوديعة.
ذلك الفتى الشجاع الذي عجزت الأطر الفكرية التي يؤمن بها عن إخضاعه ليتقوقع داخلها، وكلَّتْ مواضعات المجتمع الضاغطة عن لجمه، فثار على سفاسفها. ذلك الفتى الذي وُلد ليناضل.. ذلك الفارس الأخير.
أفرجوا عن النضال المنسوج من إهاب الوطنية.. أفرجوا عن الصحفي الشهم أحمد الوديعة.
#وديعة_حرا
الاعلامي في قناة الجزيرة/ محمد فال ولد الدين

.gif)
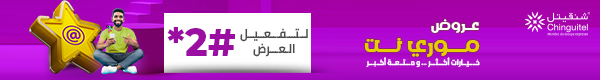
.jpg)





