
في سنة 1967 كان أول لقاء لي مع الرئيس المختار ولد داداه عندما استقبلني في مكتبه، إثر تدخل قام به أقرباء لي مقيمون في نواكشوط، حرصوا على تسوية وضعي الإداري بسرعة تمكنني من دخول دواليب الدولة. وسبق للرئيس أن كان على علم بقدومي منذ ثلاث سنوات، مع عدد من الإخوة وأبناء الأخوة وأبناء العمومة والأقرباء. فبدأ في ذلك اللقاء بالاعتذار عند عدم استقبالي قبل ذلك الوقت نظراً لارتباطاته وأجندته المزدحمة. ثم تابع شاكراً لي هذا العمل الوطني، لأن حب الوطن من الإيمان وفق تعبيره. وأكد لي أن وضع البلاد صعب ويحتاج كل شيء فيه إلى البناء، وقال إن عودة المواطنين من الخارج واجب لأن تجربتهم يجب أن توضع في خدمة الدولة الفتية. فشكرته بإيجاز، وذكرت له أنني ومَن معي، وإن كنا حاصلين على الدبلومات والتعليم الجامعي الذي تحتاجه البلاد، فإننا تعوزنا التجربة، لكننا نظل جاهزين للقيام بما نستطيع. فقد زاد الحديث على نصف ساعة قليلا، ثم صافحني قائلا إنه يتمنى أن يراني في وقت قريب. وفعلا، بعد أيام، اتصل بي في الوقت نفسه أمين التنظيم في «حزب الشعب»، أحمد ولد محمد صالح، ومدير ديوان الرئيس، صال عبدالعزيز. وأكد لي كل منهما أن الرئيس حدثه عني، وطلب مناقشة جدية للعمل الذي سيسند إلي وفق تأهيلي، والحاجة المستعجلة لدى كل واحد منها لتعزيز الهياكل التابعة له على كل مستوى. وأكد كل منهما استعداده الكامل لتحريك ما تسمح به النصوص دون تأخير لتسوية وضعي الإداري، ثم طلبا مني نسخة من ملفي.
وفي بداية السنة 1968 تم الاتصال بي لأخلُف صديقي محمد ولد داداه، مدير الثقافة، الذي ذهب في عطلة ليحضر أطروحته للدكتوراه في التاريخ حول «مفهوم السيادة في أفريقيا الشمالية وأفريقيا الوسطى». وأحسب أن ذلك كان بإملاء منه وإن لم أسأله عنه. فقبلت رغم أني لا أعرف ما هو المركز القانوني للمدير. وبموجب بلاغ عينت أميناً عاماً للشؤون الثقافية، وهو ما يساوي كتابة للدولة ملحقة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، التي كان قطاع الثقافة تابعاً لها.
وسرعان ما نشأت بيني وبين الرئيس علاقات ثقة يصح أن نصفها بالاستثنائية. فنحن لم نعمل معاً لمدة طويلة نسبياً قبل أن يضمني إليه كأحد معاونيه الأقربين، فضلا عن كوني محدود التأهيل والتجربة في تسيير شؤون الدولة. ومن جهة أخرى كان بيننا فارق في السن، مع تلك الخصوصية المزدوجة التي يمتاز بها، وهي أنه حليم وصبور إلى أقصى حد. وأنا كنت حينذاك غراً لا أخلو من بعض التسرع الذي يغذيه الحرص على فعل ما هو حسن. ومع ذلك، كنت غير مبال باحتمالات تحويلي خارج منصبي أو حتى فقدان وظيفتي. ومع مرور الوقت، بدا لي أن ألُفت نظر الرئيس إلى ما أعتبره خطأ أو صوباً أو نواقص في تسيير وتصرفات بعض مساعديه.
وفي غياب أي رد فعل من الرئيس على ملاحظاتي، شعرت بالعجز عن تغيير الأمور، وهو ما قادني إلى تقديم استقالتي مرتين، لكني كنت دائماً أتراجع عن رأيي عندما تُقدّم إلي وأنا خالي البال أسباب البطء في تسليط العقوبات. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من عجز حاد في الكوادر، هل من المناسب التخلص من أشخاص لهم عيوب، أم نحاول تربيتهم وتعليمهم وفق المستطاع، ويكون البديل هو اللجوء إلى المساعدة الفنية الأجنبية التي أعرضنا عنها لتأكيد سيادتنا ومحاولة فرضها؟ نظر إلى ثقتي الكاملة في الرجل، وأمانته الفكرية، ونزاهته الأخلاقية التي لا نظير لها، قبلت على مضض التخلي عن استقالاتي، مبيناً أنه لا يعنيني أبداً فصل مسؤولين لهم مستوى فكري عال في بعض الأحيان، لكن ينبغي الصمود أمام التحليلات التي تكون أحياناً جذابة، وأن نقول «لا» إذا لزم الأمر، كما كان الرئيس يفعل في ظروف أكثر خطورة وأهمية. وكان لابد من الاحتفاظ بالمسؤولين المعنيين ودفعهم إلى تصحيح جوهر ما يمكن تصحيحه، لأن القيادة ليست فقط بالقدرة على التأثير في الأفراد لجعلهم يرغبون في تحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً، وإنما بالتعليم، كما قال الرئيس نفسه.
وابتداءً من منتصف السبعينيات، كنتب أعرض عليه الخطب والرسائل الموجهة إلى الملوك ورؤساء الدول والمراسلات المهمة الموجهة إلى الشخصيات الأجنبية، والتوجيهات المقدمة إلى الوزراء والمسؤولين السامين في الإدارة، فيوقّع عليها ولا يغير منها شيئاً. ومع الأسف، كان لهذه الثقة جوانب سلبية. فسببها، كان يكلفني إعادة الأعمال التي تقوم بها كثير من الإدارات. فكنت أُكلف بالميادين السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مع المستشار «آبيل كومبورسي» في الميادين القانونية والإدارية. وربما كنا أكثر المعاونين عملا لأن الرئاسة هي المرحلة الأخيرة، مما يتطلب أن نعكف باستمرار على تقديم الملفات والدراسات والوثائق بأقصى قدر من الإتقان في الشكل والمضمون.
ولأن مهمات الأمانة العامة للرئاسة كانت منهكة، تحاشيت كثيراً التدخل في جزء من صلاحيات المسؤولين السامين. ومن ثم صارحت الرئيس بأن صلاحياتهم يجب احترامها، مذكراً بأنه ليس من الجيد أن نتحمّل عنهم أعباءهم، لأن الرئيس نفسه كان يقول: «الإعطاء والمنع في الوقت نفسه لا يصح». وأمام إصرار الرئيس، الذي لم يكن في أي وقت من الأوقات تهديداً، بل دعوة مخلصة، كان عليّ أن أرضخ لما دعا إليه، محترِماً الشكليات كلما سمح الوقت بذلك.
ذلك هو سياق علاقتنا اليومية من 1970 إلى 1978، ونادراً ما كنا نفترق إلا في عطلاته العائلية. وفي هذا السياق، كان يكلفي قبل أسابيع، أو أشهر، لمساعدته في إجراء التعديلات الوزارية، بالتكتم المطلق الذي يتطلبه ذلك العمل.
وكنا نلقتي مرتين أو ثلاث، وبعد نقاشات طويلة، يقرر التعديل في صيغته النهائية، ثم يأمر بالانتظار حتى يكلم أعضاء اللجنة الدائمة للحزب، قبل أن يقرر تاريخ المرسوم الرئاسي. فإذا جاء ذلك التاريخ، استدعى الوزراء المغادرين والجدد، من أجل إبلاغهم قبل ساعات من صدور البيان الذي كنت أعده بسرية تامة، ومن ثم يذاع البيان. وعسكاً لكثير من التخمينات، كنت أتدخل لإبقاء، لا لإعفاء، من يشتبهون في كوني ضدهم. كانت تلك هي غالبية تدخلاتي، لأنني أحسبهم يتمتعون بالمستوى والكفاءة اللازمين. وباستثناء حالتين أو ثلاث، كان فيهما الرئيس يتوفر على معطيات دقيقة ليست بحوزتي، فيتخذ القرار الذي يراه ضرورياً لإجراء التبديل المناسب. وكان لا يلجأ إلى هذا النوع من الإجراءات القصوى إلا إذا كان لديه ملف واضح، لأنه لا يتجسس على أحد وفق علمي، وكان يتحاشى التجريح الشخصي، سواء المباشر أو بالتلميح، ولا يتصرف إلا إذا اعترف الشخص بخطئه بعد أن يستدعيه لذلك الغرض. فليس هناك شخص محكوم عليه بأنه مخطئ مسبقاً، وإنما هنالك أخطاء محتملة في المعطيات التي وصلت إلى الرئيس.
محمد عالي شريف، «سيرة من ذاكرة القرن العشرين»

.gif)
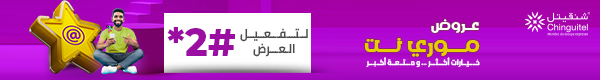
.jpg)





