
أنا و عبد الرحمن ولد أحمد سالم أشبه ما نكون بـ "كلاب خيمة واحدة"، رضعنا أفاويق صفاء الدهر و جفائه معاً.. و ما فرّقتنا أيامه أيدي سبا إلا لتجمعنا، و مهما شطت بنا الديار و بعُد المزار فإن لقلبَيْنا عناقاً أبدياً، حتى لو تراق زجاجة ماء فيما بينهما لم تتسرب.
عرفته في الثمانيات يوم كان يرد علينا في برينة قادما من إعدادية الركيز، فيبهرنا بألعابه السحرية حتى أسميناه "السّحار"، فقد كان يسحر القلوب بظرافته و خفة دمه و حسن معشره.. ثم قدم علينا من روصو رفقة صديقه عبد الباقي ولد محمد و شلة من شباب برينه لتمثيل مسرحية توفيق الحكيم "أريد أن أقتل"، فمنعها "جماعة المسجد"، حين صادف موعد تمثيلها وفاة أحد أعيان القرية.. دارت على "العلب الشرقي" رحى حرب طاحنة، فقد رفض الشباب أن يمنعوا تمثيل مسرحيتهم فاشتبكوا بالشيوخ، و كاد ابن عمتي "الشديد في الله" محمد الحافظ ولد المجتبى أن يردي الحافظ ولد محم خنقاً، فقد كان أكثر المتجاسرين على جُند العجزة.. أما أنا و صديقي "السحار" فخالفنا الكتائب إلى مجلس أوانس من جآذر الحي، خفرات بيض، تجمعن من شتّى فوق كثيب أهيَل، فـ "تمرفق" السحار لإحداهن، و أشعل سيجارته، ثم التفت إليّ ضاحكاً و قال: "أريد أن أقتل گاع الا ذَ الكان لاهِ يعدلْ محمد الحافظ ولد المحتبى لول محم مسيكين" .. و قهقهنا و غفلنا ملء قلوبنا عن مشاكلها.
كنت أتابع دراستي في محظرة النباغية، و كان "الساحر" يواصل تعليمه في روصو، و لم نكن "نلتقي إلا على منهج"، كما يقول العرجي.. كان يرسل لي مع بعض أصدقائنا المشتركين أعداداً من مجلته "العين الثالثة"... كانت تلك المجلة "المطبوعة" تجلياً آخر لعبقرية "السيحار"، فقد كان يجمع الكثير من أعداد مجلة "العربي" و "الوطن العربي" و "الموقف العربي" (و كأن صديقي الذي لم يكن قوميا عربياً أبداً يأخذ ثأره التاريخي من كل ماهو قومي، فيثخن فيه القتل) ثم يستخدم في كتابة مقالاته حروف تلك المجلات، التي يقوم بتقطيعها و لصقها ببراعة صائغ مجوهرات.
غادر "السيحار" مدينة روصو ليلقي العصى عن عاتقه في نواكشوط، فأغلق "نادي الثرثرة" الذي كان قد أنشأه مع صديقه عبد الباقي، و استبدله بجريدته الحائطية الساخرة "اشطاري"، التي أصبحت ظرافتها مضرب المثل في نواكشوط، غير أنه يوم أراد الحصول لها على ترخيص لم تكن بحوزته بطاقة تعريف فسجلها باسم توأمه "عبد الباقي".
كأن السيحار ءالى على نفسه أن يُضحِك الناس بوسيلة مرئية بعد أن انتزعت منه وسيلة إضحاكهم المكتوبة، فكان طِرفَ الشاشة الصغيرة الذي لايشق له غبار.. و هنا التقط اسمه الجديد "طوطو"..
كم رافقته في مشاويرنا التي كنا نقطعها سيراً على الأقدام من "ابيت بوليس" في عرفات" إلى دار الشباب الجديدة، فحانوت والده رحمه الله في سنكييم، و الأطفال يصيحون به "طوطو..طوطو..". مما جعله يضطر دائما لارتداء قبعة أو اعتمار عمامة أو لوث لثام.
أتذكر يوم انسحب من مسرحية "زواج المرسيديس" لأن الطالب ولد سيدي اعترض على حضوري لكواليسها. و كان طوطو قد قدّم لي في اليوم نفسه حبيبته التي ستصبح زوجته في المستقبل فمازحته "إذا كانت بطلة المسرحية ستتزوج "مرسيديس بنز" فإن سيئة الحظ هذه ستتزوج رِجلين مغبّرين من اتّبّي"
كانت عبقرية "طوطو" كالثقب الأسود الذي يبتلع الكائنات الأسطورية، فلم يكن لحمار نهمه الفطري للإبداع و التميّز أن يقف لدى عقبة، فحين غادر عالم التمثيل استوى على عرش "الماكنتوش" و "الماكيت" و "الناشر المكتبي"، فكان ملكها الذي يرتفق تاج الخلق و الابتكار فوق هامته.. و هنا خلع ربقة "طوطو" و استبدلها بطوق "عباس"، و هو اسم لاحظ لعبد الرحمن أحمد سالم منه، فلم يكن يوماً عبوساً و لا قمطريراً، و إن كانت له صولة أسد حين تنتهك حرمة مبادئه و قناعاته:
و كنت جليس قعقاع ابن شور
و لا يشقى لقعقاع جليس
ضحوك السن إن نطقوا بخير
و عند الشر مطراق عبوس
كان لدي مشروع مشترك مع عباس، في جريدة للإعلانات التجارية أسميناها "البورصة"، و نحن نضع عليها لمساتنا الأخيرة، اختفي "عباس".. بحثت عنه تحت كل حجر و مدر درب التبانة، ثم هاتفني من نواذيبو ليخبرني أن ثقباً آخر أسودَ للإبداع التهمه: السينما و عبد الرحمن سيسيغو و في انتظار السعادة.. فغضبت منه و دفنت المشروع في صحراء النسيان، و أقسمت بعدها أن لا أكلم "السيحار" و لا "طوطو" و لا "عباس"، إلا رمزاً، و لكنه يوم جاءني يعرض عليّ مشاركته في إنشاء "دار السينمائيين"، فرحت بمشروعه و تفاءلت خيراً، و اعتذرت عن المشاركة فيه لأنني لا أفهم في السينما، ولكنني أعرته منزلا من طابقين ليجعله مقراً لمشروعه، و بعد عامين من استغلاله المنزل مجاناً، رأيت أن "مكصور لعمر" تحسنت ظروفه من دولار غير مزوّر فأجرته له بسعر رمزي.. فكان إن شاء دفع و إن شاء "دفع" (من الدّفعَه).
قدفت بي الغربة في تطويحاتها نوىً شُطُراً، فلم أكن ألتقي صديقي عبد الرحمن إلا لِماماً، و لكنني كنت أحس كلما التقيته أن جزءً ناقصاً مني يكتمل به، زارني مرات عدة و انا في سجني بدار النعيم.. و زرته رفقة الفنانة العظيمة المعلومة بنت الميداح في السجن المركزي، فوجدته حسن الهندام (و إن لم يكن يلبس الزي الإفريقي الذي يعشقه)، مرتفع المعنويات، محتفظا بروح الدعابة و المرح، لم يفتأ يمص سيجارته الإلكترونية ، و كأنه يبثها حزن اهتضام وطن شاب فوداه في خدمته.
لم أشأ التأثير على العدالة في قضيته التي لم يبتّ فيها حتى الآن، غير أن قراءة نقد و تمحيص و استعبار لمحاضر الاستجواب و التحقيق و تقارير الشرطة جعلتني أجزم ببراءته، التي لم يشك فيها قلبي يوماً، و إن كان لعقلي ارتيابه و شكوكه ضربة لازب.
تربطني بعبد الرحمن وشائج و أواصر شتى، فهو صديقي و "بلدياتي" و ابن عمي (كما تؤكد الوثائق التاريخية) و قد عرفته ذكياً، ماهراً في تحريك بيادقه على رقعة الحياة، كأنه الساحر ألكسندر أليخين، صوفياً شفافة روحه كقوارير بنت الكرم، مواطناً عالمياً لا يفرّق بين المرء و أخيه بلون أو عرق أو معتقد، كريماً بماله و مشاعره كالسحاب الهتون، حسن الأخلاق، حلو العشرة، لا يعيبه إلا أنه "ما يخلصْ الدّيْن" و لكنني أرى أن الوطن أيضاً لم "يخلّصه" دينه.
ربما أستعين في تقريب شخصيته إلى أذهانكم بأبيات ناصح الدين الأرجاني:
أخلاقه نكتٌ في المجد أيسرها
لطفٌ يؤلف بين الماء و النار
لو زرته لرأيت الناسَ في رجلٍ
و الدهرَ في ساعة و الأرضَ في دار
الحرية لصديقي "سطع": السحار.. طوطو.. عباس، و عسى أن يظل نجمه ساطعاً ما تعاقب الأبردان.

.gif)
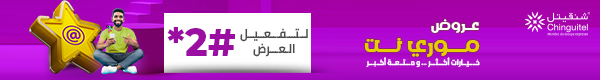
.jpg)





